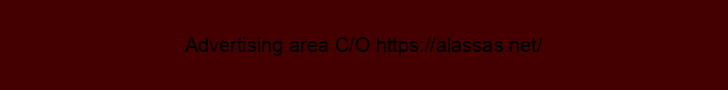مقدّمة العسّاس |
شكلت هضبة الجولان هدفا لأطماع قيادة الحركة الصهيونية منذ منتصف القرن 19، وكانت المشاريع الرئيسية للاستعمار بفلسطين ووضع موطئ قدم بالجولان تتم عبر شركات بريطانية، لكن كيف تم احتلال الجولان وتهجير ساكنيه بمختلف الطرق؟
هذه المادة تكشف كيف عمل الاحتلال على تهجير الجولان من سكانه الأصليين، وذلك من خلال الانتهاكات المباشرة، أو من خلال اللجوء إلى الحيل والخداع.
إعداد العسّاس | جيش الاحتلال زيّف حربًا في الجولان ، ولم يكلّف أحد نفسه ليعلم السكان
فيلم الدعاية “الأيام الستة” مجّد إنجازات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب وحقّق نجاحًا في مسارح السينما، إلا أن وثائِق من أرشيف الصليب الأحمر تكشف وجهًا قاتمًا في إنتاجه.
في يونيو/ حزيران عام 1976، كان يعيش ما يقارب 130 ألفًا من السكان السوريين في هضبة الجولان، وبعد مرور شهرين تقلص عددهم إلى 6396 فقط، وغالبيتهم الساحقة من الدروز.
ولم يلاحق مصير هؤلاء السكان السوريين خلال حرب الأيام الستة تحديدًا الجمهور الإسرائيلي، إذ أنّ الاحتلال السريع والاستيطان اليهوديّ الذي جاء بعده ساهم في محو ذكراهم.
في كتب التاريخ الإسرائيليّة، لم يذكر مصير السكان الأصليين لهضبة الجولان تقريبًا، بينما في موسوعة يغال كيفنيس “عندما كان الجبل وحشًا: الجولان بين سوريا وإسرائيل” (2009)، كتب أن “عدد سكان الجولان المواطنين الذين تركوا المساحة التي احتلتها “إسرائيل” كان ما يقارب 115 – 120 ألف نسمة”.
وهذه الأرقام قد تكون صحيحة، لكن ما معنى كلمة “تركوا”؟، إذ أن الباحثين لأسباب مختلفة لم يتطرقوا لمصير السكان العرب، الذين ما زالت آثار خرب قراهم جزءً من منظر المنطقة.
كما أن التوثيق المتوفر في الأرشيفات قليل جدًا، وحتى عند توفر ملف ما فيها، تكون أجزاء منه غير متاحة للاطلاع.
إقرأ أيضًا.. ما أهمية الجولان لـ “إسرائيل”؟
أُحتلت هضبة الجولان في 9 و10 يونيو/حزيران، وبعد ثلاثة أيام من القصف الثقيل بدأ تهجير السكان شمالًا، وانضمت لجموع الهاربين القوات السورية، الذي كانوا متفرقين في مناطق عدّة، وحتى الكتائب المتمرسة، التي تمركزت قيادتها في القنيطرة، تركت المكان.
هنالك تقديرات مختلفة، وأيًا منها ليست دقيقة للغاية، حول عدد السكان الذي ظلوا في الجولان بعد انتهاء المعارك وهي ما بين: آلاف قليلة حتى عشرات الآلاف، كما أنه لم يقام تسجيل منظم للسكان الباقين في كل مكان حتى 10 أغسطس/ آب من نفس العام.
بعد احتلال الهضبة، عاش السكان تحت حظر التجوّل من الصباح حتى المساء، وسكان القرى الذين خرجوا للسهول والتلال القريبة وقت المعارك حاولوا الرجوع إلى بيوتهم ولم ينجحوا.
بعد ذلك، تم إخراجهم وتجميعهم في القنيطرة وإرسالهم إلى خارج الحدود، في المقابل مُنع الدخول إلى أكثر من مئة قرية فارغة من اللواتي تركت (أو طرد سكانها).
بهذا السياق تُسلط شهادة مكتوبة، منعت من النشر على يد المسؤول عن الأمن في جهاز الأمن الإسرائيلي في أرشيف مركز إسحاق رابين، الضوء على محو القرى.
وكشف في هذه الشهادة إلعاد فيلد، وهو قائد الكتيبة التي احتلت جنوب الهضبة، ما حدّث عن كيفية اتخاذ القرار “دمرت القرى بالدبابات والمدرعات، كي لا يكون مكان للرجوع إليه”.
كما أن شهادة أخرى قدمها يتسحاك غال، الذي حضر استبيانًا أركيولوجيًا في المنطقة بعد الحرب، كتب في يومياته “ما لم تأكله الحرب دمرته الدبابات، وكل الاحترام لجيش الدفاع الإسرائيلي!”، كما أنه كتب بصورة تهكميّة عن تدمير مبنى تاريخي قديم في إحدى القرى.
المندوب الإسرائيلي ابتسم
لم يتم إخفاء الوثائق والملفات من تلك الفترة فقط، بل التوثيق المصوّر أيضًا، إذ يقول زئيف راب-نوف، وهو ناقد السينما لجريدة “دفار” عام 1968: “عندما انتهت الحرب كل من يملك قصاصة مصورة في يده، يملك كنز. السوق كان ظمئًا لفيلم عن حرب الأيام الستة”.
وتبيّن أن عملية الاحتلال لم تصوّر تقريبًا على يد جهات رسميّة، لذا قررت جهات خدمات السينما، التي مركزها الدعاية (الهسبراة) الحكوميّة إيجاد الحل وإنتاج فيلم مُعاد حول الحرب.
وأخرج فيلم الدعاية “الأيام الستة” ألفريد شتينهردت، وفي عام 2007 قال في مقابلة: “بدأنا بالتدريب وإعادة المشاهد. جنّدنا كل الجيش.. في كل مكان جاء القائد وشرح ما حدث وما كان. كنا نشير للمسؤولين كي لا يحدث خطأ في الألعاب النارية والانفجارات.. كان مكلفًا كثيرًا”.
وأضافت “كانت إعادة تامّة لكل الحرب، تم تدريب الجنود الذين شاركوا على كيفيّة التمثيل دون الإصابة في التفجيرات المزيّفة، أمّا العرب الذي سكنوا المكان لم يعلمهم أحد ما يجري”.
ويعد الفيلم ثريّ الموارد، وعرض على الشاشات في مارس 1968، وخلال ثلاثة أشهر بحسب الصحافة من تلك الأيام، شاهده ما يقارب 750 ألفًا.
وكتب راب-نوف عن الفيلم “مما يبدو لك أن أمامك شهادة تاريخيّة من الدرجة الأولى، وليس هنالك ما يدعو للخجل من إنتاجها السينمائيّ أيضًا”.
بالإمكان فهم ما دار وراء الكواليس من خلال مصادر خارجيّة، إذ في الوقت الذي لا تُظهر فيه الأرشيفات الإسرائيليّة توثيقًا لما حدث في تلك الأيام، تكشف ملفات من أرشيف الصليب الأحمر في جنيف صورة واسعة.
بعثة منظمة الصليب الأحمر، التي أقامت مندوبيّة في القنيطرة بعد الحرب، بلّغت مكاتب الإدارة عمّا يحدث في هضبة الجولان، وبلاغ المندوبيّة يوثّق الحالة الكئيبة للسكان السوريين القابعين تحت الاحتلال الإسرائيليّ، من نهب القرى، والنتائج المدمرة لإعادة تمثيل المعارك في الفيلم.
وأقيم التصوير شهرًا بعد انتهاء الحرب، دون أن تعلم أي جهّة إسرائيليّة سكان المنطقة أن التفجيرات غير حقيقيّة.
وصرّح مندوبو الصليب الأحمر في 13 يوليو/تموز: “شاركنا، أحببنا ذلك أم لا، بإعادة تمثيل متقنة وضخمة للسيطرة على القنيطرة بيد القوات الإسرائيليّة، وأعيد تمثيل ما حصل أمام البيت الذي نقطنه، وهو الذي كثير من نوافذه فُجّرت، والهدف: فيلم.”
النتائج كانت فظيعة: هرب السكان الذين ظلوا في المنطقة خوفًا ورعبًا، وتساءل مختار قنيطرة أمام مندوبي الصليب الأحمر “لماذا لم يُعلم الإسرائيليون السكان أن الحديث عن إعادة تمثيل بهدف تصوير فيلم؟”.
ومن قرية المنصورة وحدها، التي تجاور القنيطرة، هرب حوالي 300 من السكان، ثم في 17 من ذات الشهر بلّغت البعثة “أن السكان هربوا عقب إعادة التمثيل، وهذا منطقي جدًا، رأينا بأعيننا السيطرة الإسرائيليّة على القنيطرة قبل ثلاثة أيام من ذلك. أصوات المعارك ودويّ الانفجارات أخافتهم لدرجة أنهم قرروا الهروب خفيةً”.
وأضافت بعثة الصليب الأحمر “في اليوم التالي عندما أردنا المغادرة تأكدنا مما حدث: ستة فقط من السكان لم يتركوا القرية، وبحسب التعداد السكاني الذي أجراه الحكم العسكري في هضبة الجولان يوم 10 يونيو ثبّت ذلك: ستة من أهالي المنصورة ظلّوا فيها”.
وزار المندوبون “التفجيرات المزيفة” التي أدّت إلى هروب السكان وصرحوا أن ما فعله الإسرائيليون غير محتمل، ويسود القرية صمت الموت”.
كما كتبوا عن مندوب الجيش الإسرائيلي الذي رافقهم طوال الوقت “حاول جعلنا نصدّق أن السكان تركوا المكان للبحث عن أقربائهم في سوريا وإعادتهم”، لكن احدًا لم يصدق هذه الرواية، وفي البلاغ الذي قدمته البعثة يوم 18 يوليو كُتب أنهم قالوا للمرافق الإسرائيلي أن كل ما يقولونه أسطورة من نسج الخيال، فكان ردّه في المقابل “ابتسم وعبّر عن موافقته”.
عملت “إسرائيل” في أشهر الاحتلال الأولى على إخلاء هضبة الجولان من سكانها العرب، تحديدًا من المذهب السني.
وسمح القرار إبقاء السكان الدروز الذين ظلوا، ووضعهم كان أفضل بكثير، ينما قرى أخرى حُكم عليها بالطرد والتهجير، ويتضح ذلك بحسب تقرير بعثة الصليب الأحمر لقرية فرج يوم 19 يوليو، فإن القرية كانت فارغة كليًا، لم يكن فيها أي ذكر لأهاليها البالغ عددهم 60.
وحاول الجيش الإسرائيلي عرقلة وصول البعثة إلى المكان، وعند وصول أحد المندوبين إلى القريّة وصف الفظاعة التي حلّت، حيث أجزاء كثيرة من البيوت دمرت، وبيوت أخرى أشعلت أُضرمت فيها النيران هي وما بداخلها.
ووفقًا لاستنتاجات البعثة في هضبة الجولان، تمّت عملية تهجير واقتلاع مُمنهجة لسكان المكان على يد الجيش الإسرائيلي، وحتى الذين ظلّوا فقد تم نقلهم بعد انتهاء الحرب.
في أحد الملفات التابع لمنظمة الصليب الأحمر حول طرد وتهجير السكان في الحرب يظهر أنه في 11 يونيو 1967 صرّحت “إسرائيل” بوجود 1000 من السكان غير الدروز في الجولان، وبعد مرور شهر صرّحت بوجود 600.
أمّا بعد مرور شهر آخر فصرّحت بوجود 300 من السكان غير الدروز فقط، وبحسب الفحص الذي أجرته البعثة في “إسرائيل” وسوريا ظهر “أن غالبيّة اللاجئين الذي طردوا، إمّا على يد القوات المسلحة عندما وصلت إلى المكان، أو بواسطة تفعيل الضغوطات على السكان ليتركوا المكان بفترة لاحقة”.
ويدعي شلومو غازيت، وهو رئيس لجنة التنسيق الدولي والأمني في الضفّة، أنه لا يمكن رؤية هروب السكان السوريين إلى سوريا بعملية طرد وتهجير، إذ أن هذه كانت ردة فعل “إسرائيل” أيضًا على الشكاوي والادعاءات حول طرد الفلسطينيين من الضفّة الغربية إلى الأردن في سنوات الـ70 الباكرة.
بعد ذلك، استمرّ الصليب الأحمر بمطالبة “إسرائيل” بوقف تهجير السكان، وفي يوليو 1968 كتب ميخائيل كومي، والذي كان سفير “إسرائيل” في الأمم المتحدة لفترة طويلة: “تظل حقيقة أن طرد العرب من القنيطرة، التي تستمر منذ أشهر، تضعنا في كل مرّة من جديد أمام ادعاءات ومساءلات أمام الصليب الأحمر”.
لذا ينصح كومي “على ما يبدو ليس هناك من مفرّ، من الأفضل الترحيل (لسوريا)، والمشكلة مرة واحدة وبأكثر صورة جماعيّة”، وهكذا أُفرِغ الجولان من سُكّانه.
المصادر:
(1) “هآرتس”: https://bit.ly/3BHd0By